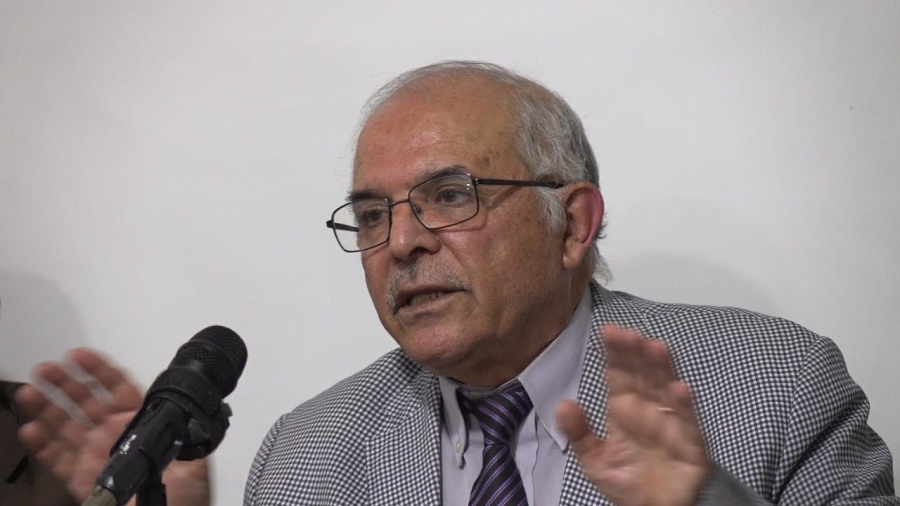اليورو يصمد ربع قرن وسط العواصف المستمرة

مرت الذكرى الخامسة والعشرون لطرح اليورو عملة بديلة للأوروبيين بصمت ومن دون احتفالات. وقد برّر المتفائلون ذلك بأن اليورو أصبح راسخا إلى الحد الذي يجعل الذكرى السنوية لظهوره مجرد حدث غير مهم، أما المتشائمون فحبسوا الانفاس خشية وترقبا للانعكاسات الدراماتيكية المتوقعة لليورو في المستقبل القريب، جراء تمدد اليمين وتوسع دائرة المديونية في عدد من دول الاتحاد خلافا لمعايير "معاهدة ماستريخت".
يعود أول كلام عن ضرورة إنشاء عملة أوروبية موحدة إلى نهاية الستينات، حين تحدث تقرير لرئيس وزراء لوكسمبورغ بيار فيرنل عن إنشاء "اتحاد اقتصادي ونقدي" أوروبي يضمن السلام ويعزز مكاسبه. وتضاعفت المبادرات الرامية إلى تثبيت استقرار أسعار الصرف بين الدول الأوروبية، بعد انهيار نظام "بريتون وودز" في عام 1971، فظهرت عام 1972 "الأفعى النقدية الأوروبية" التي استبدلت عام 1979، بالنظام النقدي الأوروبي، وفي عام 1986 وُقّع القانون الموحد الذي حدد هدف استكمال السوق الداخلية بحلول نهاية عام 1992.
في عام 1989، وضع رئيس المفوضية الأوروبية جاك ديلور تقريره الذي أسس لظهور اليورو، وحدد الانتقال إلى الاتحاد النقدي الأوروبي على مراحل ثلاث. واستنادا اليه، وُقِّعت في كانون الأول 1992 "معاهدة ماستريخت" التي نصت على إنشاء الاتحاد النقدي الأوروبي وحددت "معايير التقارب" قبل المشاركة في هذا الاتحاد وهي: سعر صرف مستقر ضمن هامش محدد، ومعدلات تضخم وأسعار فائدة منضبطة قياسا بالمعدل الأفضل أوروبيا، ومالية عامة مستدامة لا يتعدى عجزها 3 في المئة ودينها 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
في الأول من كانون الثاني 1999 طرح اليورو كعملة قانونية في أسواق الصرف الأجنبية والأسواق المالية في 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، هي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وألمانيا وفرنسا والنمسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وأيرلندا وفنلندا، بعد تثبيت أسعار صرف العملات الوطنية المشاركة بشكل دائم. وكانت تسمية اليورو اعتمدت رسميا في المجلس الأوروبي بمدريد في 16 كانون الأول 1995 وفضلت على تسميات أخرى مقترحة مثل "الفرنك الأوروبي" و"التاج الأوروبي" و"الغيلدر الأوروبي". وبعد ثلاث سنوات أصبح اليورو حقيقة كاملة، إذ طرحت عملاته المعدنية وأوراقه النقدية على الناس في 1 يناير/كانون الثاني 2002 لتحل محل العملات الوطنية بشكل نهائي في تعامل إثنتي عشرة دولة مشاركة بعد انضمام اليونان. فكانت المرة الأولى تاريخيا التي تتخلى دول على هذا النطاق الواسع عن سيادتها النقدية لاعتماد عملة فوق وطنية يصدرها مصرف مركزي مشترك.
واقع اليورو اليوم
يستخدم اليورو حاليا مواطنو 20 دولة من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي في عمليات الدفع والادخار وقياس القيمة، وهذه الدول هي: ألمانيا والنمسا وبلجيكا وقبرص وكرواتيا وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا.
وتعتمد اليورو أيضا أربع دول صغيرة استنادا لاتفاقات ثنائية هي أندورا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان، كما تعتمده بحكم الأمر الواقع دولتان هما كوسوفو والجبل الأسود.
على صعيد الأرقام، بات اليورو عملة 350 مليون أوروبي أي ما يعادل عدد سكان الولايات المتحدة تقريبا (340 مليونا)، وهو العملة الثانية الأكثر استخداما في كل أنحاء العالم كوسيلة للدفع، ويفوق عدد الأوراق النقدية المتداولة لغاية نهاية 2023 الثلاثين مليارا معظمها من فئة الـ 50 يورو حيث يبلغ عدد أوراق الأخيرة أكثر من 15 مليار ورقة نقدية.
ويتم سداد نحو 59 في المئة من المدفوعات نقدا و34 في المئة بالبطاقات معظمها بدون تلامس، باستخدام الهاتف المحمول وغيره، و3 في المئة بوسائل دفع أخرى، استنادا إلى موقع سكرتاريا الشؤون الأوروبية في مكتب رئاسة الحكومة الفرنسية.
واقع اليورو اليوم، يخالف التنبؤات المتشائمة التي أطلقها عدد من الاقتصاديين الأنغلوساكسون من أن المشروع لن يرى النور أبدا أو أن اليورو سيختفي عند أول أزمة، ومنهم الاقتصادي الشهير ميلتون فريدمان الذي ذكر عام 1997 قبل عامين من ولادة اليورو أن التباين في قوانين العمل والحماية الاجتماعية الوطنية من شأنه أن يقيد حرية حركة الاشخاص ورأس المال وهما أمران أساسيان لأي منطقة نقدية مثلى.
ورأى آخرون أن الاقتصادات الأوروبية متباينة للغاية مما يهدد بعدم الاستقرار. فأوروبا منطقة تعاني من اختلافات قوية في الدورات الاقتصادية بين الدول الصناعية والسياحية. ففي حالة حدوث أزمة في بلد معين، فإن قيود العملة الموحدة من شأنها أن تمنع أي خفض لقيمتها مما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض حاد في الدخل والقوة الشرائية قد لا يطيقه السكان، كما حصل في حالة اليونان خلال أزمتها المالية حيث اقتربت من حافة مغادرة منطقة اليورو قبل العودة والقبول بخطة تقشف مؤلمة للبقاء فيها.
المصرف المركزي الأوروبي
يعزى استمرار اليورو على متماسكا لأكثر من 25 عاما، إلى نجاح المصرف المركزي الأوروبي الذي بدأ مهماته في 1 يونيو/حزيران 1998 من فرانكفورت كمسؤول عن السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي وعن ضمان استقرار معين في الأسعار، في التغلب على أربع أزمات عاتية كان من الممكن أن تكون قاتلة؛ بدءا بالأزمة المالية عام 2008، ثم أزمة الأخطار السيادية التي طاولت خمس دول أوروبية 2012-2010، جائحة "كوفيد - 19"، فعودة التضخم العالمي المرتبط بالحرب في أوكرانيا عام 2022.
وتعمل السياسة النقدية على التحكم بكمية الأموال التي تضخ في الاقتصاد لضمان النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار العملة، بإبقاء التضخم عند مستوى أقل من 2 في المئة. ولإنجاح هذا التوازن، استخدم المصرف المركزي الأوروبي، إضافة إلى الأدوات التقليدية كأسعار الفائدة والحسم والاحتياطات الالزامية وغيرها، أدوات غير تقليدية عقب الأزمات، وأهمها التيسير النوعي الذي يوسع فئات الأصول المؤهلة لإعادة تمويل المصارف، والتيسير الكمي بطباعة الأموال لإنقاذ المصارف التجارية وتجنب الركود. وقد دفع نجاح المصرف المركزي الأوروبي في تجاوز الأزمات التي تعرض لها الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز المشرعين لقوته، فأوكلوا إليه صلاحية الإشراف على أكبر 130 مصرفا أوروبيا، مع إبقاء المصارف الأخرى البالغ عددها نحو 8300 تحت سيطرة الجهة الرقابية الوطنية المختصة.
اليورو رمز العائلة الأوروبية
يتمتع اليورو اليوم بدعم واسع النطاق، وهو رمز العائلة الأوروبية الكبرى ومن أهم العملات العالمية، وقد تلاشت تدريجيا الانتقادات اللاذعة من جانب الأحزاب المشككة فيه، التي اعتبرت أن العملة هي شكل من أشكال التنازل عن السيادة الوطنية. وكانت الزيادة المنتظمة في معدل التأييد بين السكان، التي بلغت 79 في المئة من الأوروبيين، و69 في المئة داخل كل بلد، سببا في إجبار هذه الأحزاب على التخلي عن موقفها الراديكالي لأن التمسك به سيكون مكلفا لها عند الانتخابات.
لقد جعل اليورو الحياة اليومية أكثر سهولة بالنسبة إلى الاوروبيين، من خلال إلغاء تكاليف الصرف وأخطاره، فحال دون وقوع معارك غير مثمرة في كثير من الأحيان بين الدول الأعضاء في شأن أسعار صرف عملاتها، كما زاد الثقة بالادخار والاستثمار والاقتراض، وجعل التنقل والعمل والدراسة وتحويل الأموال أسهل وأرخص داخل منطقة اليورو، كما جعل التجارة مع بقية العالم أكثر أمانا، حيث باتت الفواتير تحرر باليورو لنحو 60 في المئة من صادرات السلع إلى خارج منطقة اليورو ونحو نصف الواردات من السلع إلى هذه المنطقة.
من عملة الى عامل أمان
وباتت مقارنة الأسعار والشراء وحتى اختيار مكان التقاعد في الخارج، أسهل وأرخص، وتحول اليورو من مجرد عملة جديدة إلى ركيزة لتوفير الراحة والأمان، وإلى ارتفاع معدلات التوظيف والحماية الاجتماعية وانخفاض معدل البطالة، وهو ما تأكد منه الأوروبيون بعد رواج أخبار مآسي التضخم المفرط الذي أصاب أخيرا بلدين مجاورين، حيث سقط 80 في المئة من سكان لبنان في أتون الفقر المدقع، وبدرجة أقل في تركيا.
دعَمَ اليورو وجود سوق أوروبية موحدة أكثر شفافية وتنافسية، فعزز بذلك فرص إطلاق الصناعات الأوروبية والأسواق المالية المتطورة والمتكاملة التي تتم فيها التسوية الاجمالية بالوقت الحقيقي، وكانت باكورة الانجازات ظهور بورصة عموم أوروبا "يورونكست" في عام 2000.
نواقص اليورو وتقدم اليمين
لم يكن اليورو الحل السحري لكل مشاكل القارة العجوز، إذ لم يتمكن من معالجة نقاط الضعف الهيكلية في اقتصادات الدول الأوروبية التي استخدمته، بل أخفق في تحقيق التقارب المتوقع بين هذه الاقتصادات، على الرغم من أن ذلك هو أحد الأهداف الرئيسة للاتحاد الأوروبي، علما أن الدول الأوروبية التي لم تعتمده لم تعرف أية مشاكل نقدية.
وتبين أن الاتحاد النقدي الأوروبي لا يملك آليات قادرة على التعامل مع الصدمات غير المتماثلة. فالدول التي تواجه خللا في التوازن ولديها عملاتها الخاصة، قادرة على خفض قيمة عملاتها أو إعادة تقييمها لتصحيح الاختلالات، أما في الاتحاد النقدي الأوروبي فهي لا تملك هذا الأمر وستواجه عجزا يتطلب منها تكثيف سياسات خفض الإنفاق، مما يؤدي حتما إلى ضغوط متنوعة، من نوع تفشي البطالة والفقر، وأهم انعكاساتها الانتخابية تقدم مرشحي اليمين واليسار على السواء.
من هنا تنوعت مواقف شعوب الدول التي اعتمدت اليورو، فمنها من كانت في منتهى الرضا كفنلندا وأيرلندا وألمانيا، ومنها من كانت أقل رضاء ككرواتيا وقبرص وإيطاليا.
وتعليقا على كل النواقص والشوائب السابقة، لفت رئيس المفوضية الاوروبية السابق جاك ديلور الذي كان له دور محوري في التأسيس لإطلاق اليورو، إلى "أن اتفاق إصدار اليورو هو نقدي للغاية وليس اقتصاديا للغاية".
أما جيوفاني فارسي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأوروبية في روما، فعزا الامر إلى أن "السياسة النقدية ليست محايدة على الإطلاق"، فالنمو الاقتصادي في بلده إيطاليا كان على سبيل المثل "مخيبا للآمال بالنسبة للكثيرين على مدى السنوات الخمس والعشرين المنصرمة"، على عكس فرنسا، حيث ذكر حاكم مصرفها المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دو جالهاو أن القوة الشرائية للفرنسيين زادت خلال المدة السابقة بنسبة 26 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط في منطقة اليورو وتلك المسجلة في ألمانيا.
وكانت هناك ردود ترى أن التعليقات المشككة والمخيبة لليورو ليست عادلة، على أساس أن البنيان لم يكتمل بعد. فالأستاذ فارسي يرى أن السياسة النقدية ليست سوى عنصر واحد من عناصر السياسة الاقتصادية، فـ"عندما يكون لديك سياسة نقدية واحدة من دون سياسة مالية واحدة فأنت تفقد إحدى ساقيك"، ويرى أن الإصلاحات، خصوصا في السياسة الضريبية الموحدة، تعزز قدرة منطقة اليورو على استيعاب الصدمات الاقتصادية.
الخطر المالي من اليمين الصاعد
لا يزال الاتحاد المصرفي الأوروبي في حاجة إلى استكمال وضع قواعده التنظيمية والاشرافية، وارساء نظام لضمان الودائع عند التعثر المصرفي، والأمر الأخير تربطه ألمانيا بتنفيذ دول الجنوب شروطا محددة. من المفترض أيضا استكمال اجراءات إصدار اليورو الرقمي لاستخدامه ابتداء من مطلع عام 2026 كوسيلة دفع جديدة، فورية وآمنة ومجانية، للأفراد والشركات.
يبقى الأمر الداهم هو التقدم الذي سجله اليمين أخيرا في الانتخابات التشريعية الاوروبية والمتوقع أن يتمدد في المجالس الوطنية لبعض دول اليورو، وهذا ما لفت اليه أحد تقارير المصرف المركزي الأوروبي عن الاستقرار المالي، حيث أشار إلى أن صعود الأحزاب الشعبوية في أنحاء أوروبية جعل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التقليدية لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي "أقل يقينا".
وأضاف التقرير أن الفشل الملحوظ للأحزاب الوسطية أو الديمقراطية الاجتماعية في التعامل مع الضائقات الاقتصادية، أدى إلى فتح الباب أمام الأحزاب الناشئة ذات الحلول المتطرفة سواء من اليمين أو اليسار.
ويرى ستيف بارو، الخبير الاستراتيجي في مصرف "ستاندرد تشارترد"، أن تحذيرات المصرف المركزي الأوروبي في شأن الشعبوية يجب تقييمها على أساس كل دولة على حدة. فالاشكالية تبرز إذا تم فرض قيود أو غرامات على دولة ما، أو إلزامها اتخاذ تدابير اجتماعية من نوع تفكيك دولة الرفاهية وخفض الإنفاق الاجتماعي بسبب مخالفاتها المتعلقة بالموازنة. من شأن ذلك أن يخلق بؤرة أكبر للحركة الشعبوية التي تتمرد ضد المطلوب أوروبيا، بحيث تتعمق الأزمة وتختلط الأمور بين القضية ومعالجتها، وتختلف ردود الأفعال بين يسار متطرف مؤيد لأوروبا يتحدى التقشف، وآخر يميني متطرف مناهض لأوروبا بشكل علني.
الانحرافان الفرنسي والإيطالي
تمثلت الاشكالية التي خلقتها "معاهدة ماستريخت" عام 1992 في أنها أنشأت اتحادا نقديا لكن مع قاعدة "عدم انقاذ"، خشية أن تستغل الدول المسرفة الأعضاء الأكثر مسؤولية ماليا، كما تراها بريجيت غرانفيل، أستاذة الاقتصاد في جامعة الملكة ماري في لندن. فقد كشفت أزمة اليورو في 2012-2010 الخلل القاتل في هذا التصميم، فالحظر المفروض على المركزي الأوروبي بأن يكون المنقذ من خلال لعب دور الملاذ الأخير للإقراض، من شأنه أن يهدد الاتحاد النقدي، وبالتالي المشروع الأوروبي بالكامل.
وتمثلت التسوية التي عقدت، في تمكين المصرف المركزي الأوروبي من شراء كميات غير محدودة من سندات دول منطقة اليورو، شريطة أن تكون هناك خطط موازنات متسقة مع القواعد المالية التي تحددها المفوضية الأوروبية في بروكسيل. لكن كان هناك غالبا تمويه لعدم الامتثال، كما حصل في الامتياز الذي قدم إلى فرنسا، ثاني أكبر دولة في منطقة اليورو، إذ تم تقييم ديون الحكومة الفرنسية بالدرجة المرتفعة نفسها تقريبا التي تقيم بها السندات الألمانية، على الرغم من غياب أي تحسن حقيقي في الموقف المالي الفرنسي، وهو أمر كشفه انتهاء تعليق القواعد المالية بعد "كوفيد - 19"، إذ تبين أن عجز الموازنة الفرنسية بلغ 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأبعد من أي وقت مضى عن عتبة الـ 3 في المئة المقررة في ماستريخت، كما بلغ الدين العام 110 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأي قرارات أو تدابير لخفضهما من قبل أي حكومة وسطية، ستكون بالتأكيد غير شعبية، بل ستعزز مواقع الأحزاب اليمينية.
إيطاليا على مسار الدين والعجز
وينبه ديزموند لاكما، الاستراتيجي السابق في صندوق النقد الدولي، إلى أن إيطاليا تسير هي أيضا على مسار دين عام مرتفع وعجز في الموازنة، تجاوزا 137 في المئة و7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن الواضح أن وجود فرنسا وإيطاليا على المسار الانحرافي نفسه في الدين العام والموازنة العامة، أمر خطير بالنسبة إلى مستقبل اليورو، وخصوصا أن المصرف المركزي الأوروبي لم يعد يشتري سندات الدول الأعضاء فيه على نطاق واسع.
وتتفاقم الخطورة إذا علمنا أن دولا أوروبية أخرى تتعايش مع هذا الانحراف المالي في المؤشرات الأساسية، وهي بلجيكا وهنغاريا وبولونيا وسلوفينيا ومالطا ورومانيا، وكلها تخطى دينها العام وعجز ماليتها العامة عتبتَي 60 في المئة و3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يحتم عليها اتخاذ إجراءات تصحيحية وإلا تعرضت لعقوبات مالية يبلغ مقدارها 0.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهي عقوبات تبقى حتى تاريخه نظرية لأنها لم تفرض البتة في السابق.
إن صعوبة استعادة الدول الأوروبية السابقة قدراتها على تحمل الدين العام من خلال تقشف الموازنة، كما استحالة استخدامها خفض سعر الصرف كوسيلة لتعزيز الصادرات تعويضا عن انخفاض الطلب المحلي نتيجة لشد الأحزمة، من شأنها أن تفضي بسياسة التقشف إلى نتائج عكسية، حيث أنها ستؤدي إلى تقليص القاعدة الضريبية وإلى ركود اقتصادي. هذا كله يشير إلى تلبد الغيوم، وينذر بأيام مقبلة قاتمة لمنطقة اليورو مع ارتفاع أصوات دعوات سياسية ضاغطة لليمين الصاعد لتقليص صلاحيات السلطات المركزية للاتحاد الأوروبي وفي مقدمها بالطبع سلطات المصرف المركزي الأوروبي.