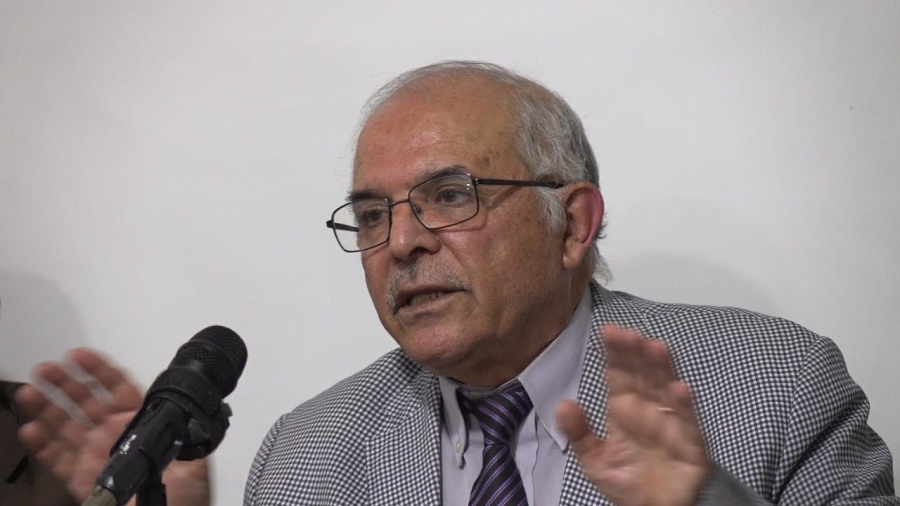الخروج من تقديس ما ليس مقدسا: أنسنة المجال العمومي بدلا من تديينه

إبراهيم غرايبة
يحاول هذا المقال أن يستوعب إسلاميا الإنتاج الفكري الذي بذله ماركس وانجلز وارنست بلوك لتحرير فكرة الدور الصحيح الممكن للدين في المجال العمومي والتفسير الاقتصادي والمادي للتاريخ الاجتماعي. (وهو بالمناسبة ما فعله ابن خلدون من قبل) يحتاج المقال إلى صبر واحتمال لأجل استيعاب وهضم أفكار كتبت في مئات الصفحات. وأقدر ابتداء أن فيسبوك ليس مكانا لنشر مقالة فكرية لا تقرأ تصفحا، لكن ما باليد حيلة!
كان من أسوأ ما أصاب عمليات التحديث والاستيعاب المعاصر للإسلام، التي بدأت في ظلّ الدولة العربية الحديثة؛ إعادة فهم المعارف والمنجزات الغربية بمنظور إسلامي، بدلاً من العكس؛ أي دراسة الدين وإعادة فهمه بمدخلات العلوم الحديثة، التي تطورت في عالم الغرب، فصار لدينا أنظمة إسلامية في السياسة والاقتصاد، والبنوك، والتعليم، والإعلام، وأسلوب الحياة، والعمارة، هي ليست إسلاماً وليست حضارة، بدلاً من أن يكون لدينا عمليات فهم واستيعاب للدين في فضائه العام، بما هو حالة أو ظاهرة ثقافية أو اجتماعية، فتكون لدينا سوسيولوجيا الإسلام وأنثروبولوجيا الإسلام، وبيولوجيا السلوك الإسلامي، أو في عبارة أخرى؛ كان يجب أن تكون لدينا أنسنة للدين، بدلاً من تديين الإنساني؛ ففي الأنسنة يكون في مقدورنا أن ننشئ حياتنا كما يجب، وكما نحب أن تكون، ويكون الدين في السياق المعرفي والاجتماعي الذي يخدم هذا الاتجاه، أو يكون التدين هو ما نتوقعه من الدين بما تمنحنا هذه التوقعات مدركاتنا الحضارية والاجتماعية، لكن في التديين نمضي بحياتنا وشأننا المشهود لنخضعه للغيب الذي لا يعرفه أو يدركه أحد.
في ظلّ غياب هذا الإدراك؛ صارت تقود حياتنا مؤسسات وجماعات تنشئ معرفتها وقراءتها وفهمها للدين، وصار الدين هو ما تتوقعه منا المؤسسات والجماعات الدينية والسياسية، وتصف توقعاتها منا، التي هي مطالب وطموحات وأهواء سلطوية؛ بأنّها الدين، أو كما في جاء في القرآن الكريم: ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّه...﴾ [آل عمران: (78)]، لكننا نملك اليوم فرصة عظيمة في صعود الفردية، وتدفق المعرفة وتداولها وإنتاجها على نطاق واسع، يتيح لكلّ إنسان أن يشارك فيه، وأن ننشئ حاضراً جديداً، نحدده من معطيات الحاضر نفسه، غير ملزمين بالمؤسسات والمنجزات التي تخضع لمراجعة قد تعصف بها.
تمكن اليوم؛ ملاحظة أنه يجري في عالم الإسلام مراجعة للحالة الدينية، وأنّها مراجعة تصاحب صعود الفردية في ظل الشبكية التي تعيد صياغة علاقات القوة، والتأثير والتنظيم في الدول والمجتمعات، وفي ذلك؛ فإنّ في مقدور الفرد اليوم أن يتدين بلا حاجة إلى مؤسسة دينية أو سلطة سياسية، ومثل الطابعة ثلاثية الأبعاد أو الموبايلات الذكية؛ فإنّ التدين الفردي يمثل تحدياً للسلطة في تنظيمها للنشاط الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وسواء تزايد أو تراجع تأثير الدين ووجوده في حياة الناس وتصوراتهم، والحقائق الأساسية المحيطة بالكون والحياة؛ فإنّه يتخذ أوضاعاً جديدة، ومعاني جديدة أيضاً؛ فالنص الديني يقرأ في سياق العلاقة به، ويفهم ويتشكل كما يقرأ، وفي استيعاب الإنسان لشبكة الدلالات التي صنعها بنفسه، ويجد نفسه جزءاً منها؛ فإنه ينشئ نظامه الثقافي ورؤيته لحياته وعالمه الخاص.
يستعاد اليوم، بفعالية أكثر من السابق، التحليل الماركسي للدين ودوره في الحياة الاجتماعية والعامة؛ ففي صعود الدين والتطلعات الدينية، التي تبدو مستقلة عن التطلعات الاقتصادية والمادية، يبدو الدين مرشحاً لعمليات استيعاب ومواءمة، يمكن أن تلجأ إليها الجماعات الإصلاحية والاحتجاجية، كما الطبقات الاجتماعية والمؤسسات التقليدية؛ بل يبدو الدين اليوم يخرج من يد السلطات السياسية إلى المجتمعات والجماعات، وهذا لا يعني بالضرورة أنّ جماعات الإسلام السياسي هي الوحيدة التي تشكل بديلاً للمؤسسات والطبقات السائدة؛ بل إنّ الإسلام السياسي يواجه التحدي نفسه الذي تواجهه الأنظمة السياسية، والحال أنّ الإسلام السياسي ظهر مشروعاً للأنظمة السياسية، في محاولتها بناء نموذج للدولة الحديثة منسجم مع الإسلام، وفي أزمة الدولة الحديثة؛ إنّ الإسلام السياسي يعيش الأزمة نفسها.
يرى ماركس وإنجلز الدين كحالة اغتراب تعتم وتحجب إدراك وفهم العالم الاجتماعي، الدين كعامل لإضفاء الشرعية على الهيمنة، الدين الذي يتخلله ويتقاطع معه صراع الطبقات، وهو خطاب (الماركسي) يتكون من تحليل سوسيولوجي ونقد فلسفي سياسي للدين، يرث فلسفة التنوير ومنهج لودفيج فيورباخ (1804 – 1872)، لكنّ فلاسفة ماركسيين معاصرين، لاحظوا الفرص والإمكانات الجديدة للدين، كما أنّ بعضهم، في دراستهم للبروتسنتية، لاحظوا نمطاً جديداً مختلفاً في الاستيعاب الديني، عمّا درجت عليه المؤسسة الدينية الكاثوليكية على مدى التاريخ، لكن أيضاً، وكما يلاحظ إنجلز؛ فإنّ المسيحية في منشئها كانت حركة احتجاج وانعتاق استقطبت المهمشين والمستضعفين، تماماً كما اجتذبت الاشتراكية العمال في مواجهة الرأسمالية.
يقول ماركس: الحاجة إلى الدين هي في جانب منها تعبير عن الحاجة الواقعية، ومن ناحية أخرى احتجاج على الخطر الواقعي، الدين هو حسرة الإنسان المضطهد المظلوم، هو روح عالم بلا قلب، روح الظروف الاجتماعية التي استبعدت منها الروح، الدين هو أفيون الشعوب، وقد اجتزئت العبارة الأخيرة من مقولة ماركس، واشتهرت كرأي ماركسي ينتقد الدين! لكن يبدو واضحاً أنّ الأمر ليس كذلك.
ويقترح ماركس إمكانية استيعاب وفهم ديني ينتقل من السعادة الوهمية، التي تمنحها الجماعات والمؤسسات الدينية إلى سعادة فعلية، والتخلي عن الأوهام إلى الواقع، بما هو العالم والأرض والقانون والسياسة، وقد خلق الإنسان خارجه قوة لا يعرفها مثل قوته الخاصة ثم استعبدته.
كانت الدولة، في تشكلها وتطورها، دينية غير كاملة، تظهر تعاملاً سياسياً تجاه الدين، وتعاملاً دينياً تجاه السياسة، أو هي إعادة إنتاج علماني للدين، يتحرّر فيه الإنسان سياسياً من الدين ليخضع للقانون، ويتحول البشر بتطويرهم للإنتاج المادي وعلاقاتهم المادية، يتحولون مع هذه الحقيقة الخاصة بهم وبفكرهم ونتاج فكرهم؛ من الوعي الذي يحدد الحياة إلى الحياة التي تحدد الوعي.
والحياة المحددة للوعي هي الظروف والعلاقات الاقتصادية، هكذا، يقول ماركس، تجب دراسة العلاقة مع الاقتصاد الخاص بكل حقبة وبكل مجتمع؛ باعتبار أنه، كما يقول دي سيرتو: في مجتمع ما؛ الرموز الجمعية والأفكار لم تعد السبب، لكنّها انعكاس للتغيرات.
طوّر الفيلسوف الماركسي، أرنست بلوك (1885– 1977)، فكرة البنى الروحية؛ التي تنشئ إلى جانب الرغبات المادية دوافع للروح الإنسانية، خصوصاً في الفترة التي تهيمن فيها المشاعر والانفعالات الدينية. كما يلاحظ إنجلز فرقاً بين المعسكرات الدينية في الصراعات الاجتماعية؛ ففي ثورة الفلاحين، في القرن السادس عشر، كان ثمة معسكر كاثوليكي، أو "رجعي"، وكان هناك أيضاً معسكر لوثري برجوازي إصلاحي، أو ثوري، يمثله توماس مونزير؛ الذي أراد تثوير المجتمعات والدين أيضاً.
من وجهة النظر السوسيولوجية؛ يمكن إرجاع الفضل إلى إنجلز، لكونه قد أشار إلى واقع أنّ الصراعات الاجتماعية تعبّر وتتخلل العوالم الدينية، وأنّ التغييرات الدينية تختلف تبعاً للأوساط الاجتماعية، ويميز إميل بين في دراسته للممارسات الدينية والطبقات الاجتماعية، التي نشرت عام 1956؛ بين مسيحية بورجوازية، ومسيحية شعبية، ومسيحية الطبقات الوسطى.
اهتم إنجلز بالتقارب الممكن إقامته بين المسيحية والحركة العمالية؛ ففي كتابه مساهمة في تاريخ المسيحية الفطرية، كتب يقول، مثل الحركة العمالية الحديثة كانت المسيحية في الأصل حركة للمضطهدين: لقد ظهرت بداية كدين للعبيد وللانعتاق، دين الفقراء والمحرومين من الحقوق، دين الشعوب المقهورة أو المشتتة من قبل روما، كل من الاثنتين المسيحية والاشتراكية العمالية، تعدان بخلاص قريب من العبودية والبؤس، المسيحية تضع هذا الخلاص في الحياة الآخرة، في حياة ما بعد الموت، في السماء أما الاشتراكية فإنها تضع هذا الخلاص في هذا العالم، في تغير المجتمع.
هناك بالطبع فرق بين الدين والثقافة؛ فالمتدين يرى الدين رسالة من الإله لترشده في حياته وبعد مماته، لكن لا مناص من فهم هذه الرسالة وملاحظتها، في ظلّ الثقافة والتجارب الإنسانية المتشكلة، وليس ذلك لإثبات صواب الدين أو زيفه، حتى إن كان الدين في حالته الأصلية النقية أكبر من قدرات الإنسان، وكانت الثقافة من صنع الإنسان، لكن لا مفرّ من فهم الدين ودراسته بالأدوات الإنسانية، العلم واللغة والتجربة والحضارة، وأن يؤمن الإنسان، فرداً أو جماعات، بالدين، على النحو الذي تعبّر عنه النصوص الدينية؛
لا يغير أيضاً من حقيقة أنّ الثقافة والدين هما من مظاهر حياة الإنسان (غير الدينية)، ورغم أنّ هذه المقولة صارت بديهية في عالم الغرب، وتكوّنت في ذلك معرفة واسعة ومكتبة هائلة من الكتب والدراسات والأفلام والمسرحيات والروايات والقصص والفنون، فما تزال في عالم المسلمين فكرة خيالية متطرفة!