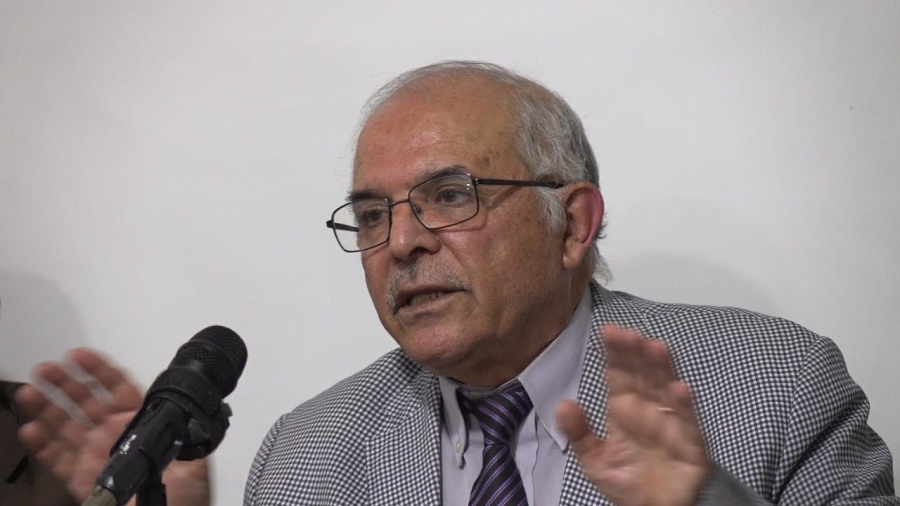التحفيز الديني عمليات نفسية لا تدل على صواب أو خطأ ويمكن أن تكون جريمة وتضليل

إبراهيم غرايبة
"قالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (سورة طه 96)
يفعل الدين، أيّ دين، لأتباعه حالات نفسية وحوافز قوية وشاملة ودائمة، هذه المشاعر والأفكار والطمأنينة التي يحصل عليها المؤمنون مرتبطة بالدين وطبيعته، ولا فضل في ذلك أو ميزة لجماعة دينية، ولا يختلف فيها دين عن آخر، وإن كانت الجماعات بالطبع توقظ هذه الحالات وتحركها، وهنا يحدث خلل كبير؛ عندما تفصل هذه الحالة عن الدين، وتمنح لشخص أو جماعة، هذا الانتحال للدين الذي تمارسه
جماعات الإسلام السياسي وجماعات دينية أخرى، يحرف الدين عن غاياته ومساره ويؤثر في السياسة والاجتماع على نحو مفتعل، كما يحدث -على سبيل المثال- عند استخدام المنشطات في التنافس والمباريات الرياضية.
تمنح الممارسات والرموز الدينية طاقة كبرى للمؤمنين، مثل: الشجاعة، والاحتمال، والاستقلال، والمثابرة، والثبات الشغوف على الآراء والأفكار والمبادئ، وهي فضائل يمارسها الهندي الأمريكي في السهول في رؤياه ونشدانه، وهي نفسها التي يحاول أن يعيش عليها: بينما يحصل فيه إحساس بالوحي والكشف يرسّخ في الوقت نفسه أساساً بالاتجاه المطلوب، كما يحصل عليها صوفي متأمل سواء
كان هذا المتصوف، مسلماً أو هندوسياً أو بوذياً، وينشأ عنها أيضاً ضبط للنفس والتزام بالقواعد والمثل، وشعور بالذنب والتقصير والعار عند الوقوع في الخطأ، وهذا الإحساس بالواجب الأخلاقي يصون المجتمع وقيمه، ويجعل لمبادئ مثل الملكية، على سبيل المثال، قدسية تمنع السرقة والاختلاس والغشّ، كما ينشأ ضمير عام ينشد المغفرة والصواب، وينشئ هذا الضمير بدوره منظومة من الأفعال والالتزامات التي تحمي المجتمعات والقيم المنظمة للاجتماع والأخلاق.
إنّ الضمير، في أبسط تعريف ممكن له؛ هو أن نشكّل أنفسنا بوعي الذات وإعادة وعي الذات، لنكون ما نحب أن نكون، ونفعل ما يجب فعله لنكون ما نحبّ، وفي ذلك يتشكل أيضاً الشعور بالخطأ والصواب، ودافع لفعل الصواب وتجنّب الخطأ، من غير حافز أو دافع مادي أو قانوني أو ديني، لكنّ الدين كان على الدوام محفزاً وداعماً أخلاقياً، وهنا تتشكل ضرورات التأكيد على عدم المساس بهذه العلاقة المعقدة والمهددة بين الإنسان والأخلاق؛ ذلك أنّ من قواعد نجاحها أن تعمل من غير تدخل تنظيمي مباشر، لتظلّ تتحرك وتتفاعل معبرة عن إدراك الجماعات بالصواب والخطأ.
ما تفعله جماعات الإسلام السياسي؛ هو توظيف هذه التطلعات والأشواق الروحية للإنسان وتوقه الدائم والملحّ للمعنى في عمليات سياسية وتنظيمية، أو الدفع بالمنظومة الأخلاقية لتعمل في تضامن محدود جماعاتي أو فئوي، ثمّ، ويا للهول، تحويل الرذائل، مثل الكراهية والغش والسخرية والاستعلاء والكذب، إلى فضائل، عندما يتعلق الأمر بالعلاقة مع الآخر، وهو ما وقع فيه أهل الكتاب من قبل، كما وصفهم القرآن الكريم: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ﴾؛ ذلك أنّه على الدوام كانت لقادة العمل الديني فرص وقدرات في التأثير على المؤمنين وفي صناعة المعنى نفسه على غير النحو الذي تشكّل عليه، أو كما أراده الله تعالى، وعلى نحو رمزي يشبه ذلك قصة السامري الذي استخدم الأثر المقدس للرسول، لينشئ به وعياً واتجاهاً مضادّاً ومختلفاً عن الرسول: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ (95) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ
يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾ كيف يحول المعنى أو الأثر المقدس إلى ضدّه؟ هذا ما تفعله الجماعات عندما تمضي بقدرتها وتأثيرها الديني إلى غير، وربما عكس، ما أراد الدين. أو تحمل هذا المعنى الديني إلى مصالح وأهداف سياسية واقتصادية، هي وإن لم تكن سيئة، لكنّها ليست ديناً، وليست أيضاً مبادئ ثابتة ومقدسة، وفي ذلك؛ فإنّ الجماعات تحرك الثابت (الدين) وتثبت المتحرك (الحياة السياسية والاقتصادية).
يصف كليفورد غيرتز النماذج الدينية بأنّها؛ تشكّل المؤمنين عن طريق خلق مجموعة متميزة من الطباع في نفس الشخص المتدين العابد (ميول، قدرات، نزعات، مهارات، عادات، قابليات، استعدادات)؛ ما يكسب مسار أفعاله ونوعية تجربته صفة ملازمة دائمة، وتتشكل الحوافز في قالب توجيهي، تصف مساراً كلياً معيناً، وتنجذب نحو إنجاز عادة ما يكون مؤقتاً، لكنّ الحالات النفسية لا تتجه إلى مكان، فهي تنبعث من ظروف معينة، ولكنّها لا تستجيب إلى نهاية أو غاية ما، فهي مثل الضباب؛ تهبط ثم ترتفع.
لكن في مقدور الجماعات والمؤسسات الدينية أن تساعدنا، بدلاً من ذلك، في صياغة مفهومات عن نظام عام للوجود؛ فالإنسان يميل إلى الإيمان، ولأن ينشئ حياته وفق تصورات وأفكار معدّة لفعل ذلك، يقول الفيلسوف الأمريكي، وليم جيمس (1842 – 1910): نؤمن بكلّ شيء نستطيع الإيمان به، ولو كان في مقدورنا لآمنا بكل شيء، ويقول عالم الإنسانيات البريطاني، إيفانز بريتشارد (1902 – 1973): "أهم ذخر لدينا هو دائماً رموز توجّهنا العام في الطبيعة، على الأرض، في المجتمع، وفي ما نفعل: الرموز التي تخص فلسفتنا ونظرتنا إلى الكون ومقاربتنا للحياة".
يقع الخلل والافتعال في تحريك القلق الإنساني المتأصل تجاه الخطأ والصواب إلى يقين؛ لأنّ إضفاء اليقين على غير اليقيني يشكل النظام الأخلاقي على نحو مخيف وخطير، ففي حالة عدم اليقين تكون الفضيلة في الجهل والألم! وفي ذلك؛ فإنّ أسوأ ما يمكن أن يصيب الجماعات الإسلامية السياسية حين تمنح الأتباع والمؤيدين شعوراً براحة الضمير تجاه الخطأ، فالمبادئ التي تشكّل النظام الأخلاقي قد تروغ من فهم الإنسان، على حدّ وصف لينهارت، كما تروغ منه في الغالب التفسيرات الرصينة للأحداث الغريبة، أو تروغ في الأشكال الفعالة للتعبير عن الإحساس؛ فالمهم -على الأقل بالنسبة إلى الإنسان المتديّن- هو أن يتم تبرير هذا الروغان والاستعصاء على الفهم، وتأكيد أنّ هذا الروغان ليس نتيجة واقع يقول بعدم وجود هكذا مبادئ أو تفسيرات، أو أشكال، وأنّ الحياة غير معقولة، أو يعدم جدوى أيّة محاولة لإيجاد معنى أخلاقي أو فكري أو عاطفي للتجربة.
نقاط الغموض والتناقض لا ينظر إليها على أنّها هي المحصلة النهائية للتركيب الأخلاقي للواقع؛ بل هي المحصلة العقلانية أو الطبيعية أو المنطقية لهذا التركيب، وبإمكان المرء أن يختار ما يناسبه من لائحة النعوت المذكورة؛ حيث إنّنا لا نجد منها ما هو ملائم تماماً، ومشكلة المعنى تتعلق بإثبات، أو على الأقل، التعرّف إلى عدم إمكانية التخلص من الجهل والألم والظلم على المستوى الإنساني، بينما ننكر في الوقت ذاته أنّ هذه الأشياء غير المعقولة تميز العالم ككلّ، وإنه لمن ضمن الرمزية الدينية، وهي رمزية تصل دائرة وجود الإنسان بدائرة أوسع، تُرجى فيها نوال الراحة من ضمن هذه الرمزية، ويتمّ الإثبات والإنكار .