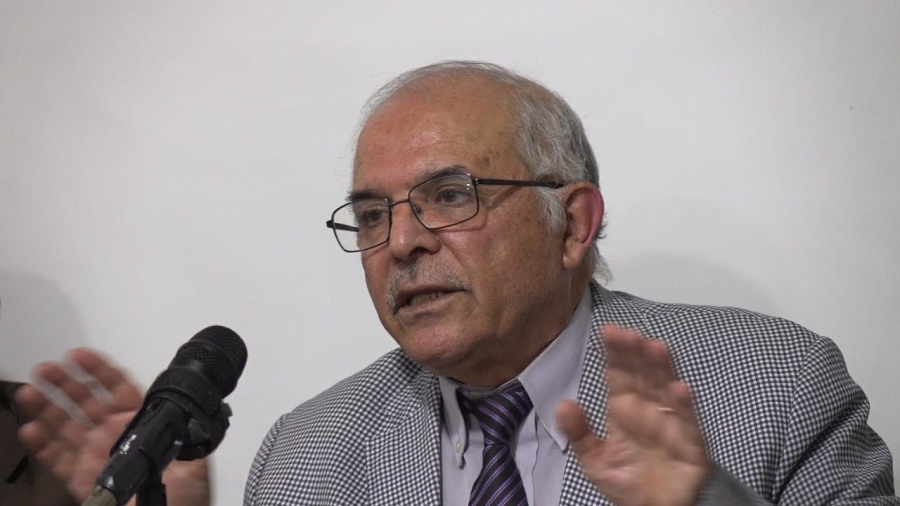كيف يفكر جعفر حسان؟

أحمد أبو خليل
أسارع للإشارة إلى ان مرجعي في المقالة التالية هو ما كتبه الدكتور جعفر بنفسه. وبالطبع مع تحملي مسؤولية اختيار الصياغة في هذا المقال.
فقد أصدر الدكتور جعفر حسان عام 2020 كتابا بعنوان لافت هو: "الاقتصاد السياسي الأردني.. بناء في رحم الأزمات". والكتاب مهم بغض النظر عن مدى الاختلاف أو الاتفاق معه. وللأسف أنه لم يثر حينها ما يكفي من النقاش، رغم أنه محفز لذلك عند كل من خصومه وأنصاره. وقد طالعته في حينه واليوم عدت لنسختي ووجدتها مليئة بالخطوط والخرابيش التي أستخدمها للإعجاب أو للاحتجاج أو الاستغراب، والكتاب فيه الكثير مما يستدعي مثل تلك الخرابيش المتنوعة الأهداف.
ربما كان هذا الكتاب الأول الذي يحمل في عنوانه مفردات "الاقتصاد السياسي الأردني". فالاقتصاد السياسي هو عنوان توقف الاقتصاديون في العالم عن الحماس له، وخاصة في العالم الثالث، فهو يستدعي أن يعالج الاقتصاد والمجتمع معا، وأن ينظر إلى الفئات المستفيدة والمتضررة من السياسات الاقتصادية، وأن تتحدد المسؤوليات، وأن لا يقتصر البحث على الأرقام الكمية المتعلقة بالاستثمار والادخار والاستهلاك، بل يتعداه إلى المحتوى الاجتماعي لها.
هذا لا يعني أن الكتاب –بتقديري- كان فعلا يمثل عنوانه بشكل كامل أو منصف، فهو بتقديري كان انتقائيا في الحركة بين الاقتصاد والمجتمع والسياسة.
الكتاب يحتاج لنقاش تفصيلي، وخاصة بعد أن كلف بتشكيل الحكومة، إن هذا يعني أن ما ورد فيه سيكون حاضرًا. ولكن حتى لو لم يحصل ذلك، فإن كثيرا من الخطوات الاقتصادية الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة خارج إطار الحكومة أو بدا وكأنها مفروضة على الحكومة، إنما تجد فعلا ملامحها في الموقف الذي عرضه الدكتور جعفر في كتابه. إن الدكتور جعفر على العموم كان ولا يزال في مركز وظيفي هام. وهو عموما ابن مؤسسات الدولة في مواقعه العليا وخدم فيها طيلة حياته العملية، بمعنى أنه لم يأت من خارج المؤسسات ككثيرين غيره.
يقوم الكتاب على توصيف رئيسي لمرحلتين في التاريخ الاقتصادي والتنموي الأردني، الأولى منذ نشأة الدولة (الإمارة) وتنتهي مع عام 1990 وقد خصص لها الكتاب نحو 60 صفحة من أصل 280 وأطلق عليها المرحلة "الاتكالية"، والمرحلة الثاني وضعت عموما تحت عنوان "الاعتماد على الذات" وهي تغطي باقي الفترة حتى صدور الكتاب عام 2020.
سوف نلاحظ ان مفهوم "الاتكالية" في الكتاب متشعب، فهناك اتكالية كلية عامة من الدولة على المعونات والمساعدات الخارجية، واتكالية متبادلة ومتبدلة بين القطاع العام والخاص، كما يتشعب مفهوم "الاعتماد على الذات" فيصبح "تشاركية" او "انتاجية"…
من الواضح أن حساسية نقاش بعض الأمور وطريقة طرحها في الشارع فرضت على المؤلف أن يكون حذرًا أو مواربًا في اختيار المفردات.
فلكي يثبت مسألة الاتكالية على الخارج في فترة الإمارة (1921- 1946)، فهو يكرر الإشارة إلى المعونة البريطانية، ولكنه لا يذكر واقعة ان المعونة كانت في أغلبها تذهب للإنفاق على القوة العسكرية البريطانية أو على الخدمات التي تقدم لهذه القوة على الأرض الأردنية، وقد استمر ذلك حتى عام 1956 عند إلغاء المعاهدة مع بريطانيا، ويوضح ارشيف المراسلات مع الحكومة البريطانية حجم المحاولات الأردنية الرسمية لكي تدخل هذه المساعدات إلى الموازنة وتكون تحت تصرف الحكومة الأردنية، وعندما توالت الضغوط لتحقيق هذا الهدف بعد تعريب قيادة الجيش، أصبح مطلب إلغاء المعاهدة، أي وقف المعونة، بريطانيا أكثر منه أردنيا.
في الواقع أمضى المجتمع الأردني ثلاثة عقود التأسيس الأولى وهو يعيش درجة من الاستقلالية الاقتصادية عن الدولة. بل صدرت قوانين كثيرة تفرض التمويل الذاتي للمشاريع التنموية كإنشاء المدارس والمستشفيات والطرق وآبار المياه وحتى اعمال الحراسة والأمن المحلي.
في الفترة اللاحقة، يتجاوز الكتاب طبيعة المعونات التي فرضتها الظروف السياسية، ومنها حضور الأمريكي محل البريطاني كدولة نفوذ، إضافة إلى استحقاقات دعم تشغيل واستيعاب اللاجئين... إلخ. هو يذكر ذلك بالطبع، لكنه يهوّن من أهمية محتواها ذاك ويعرضها مجرد "اتكالية".
غير أن التجاوز الأبرز في الكتاب هو لعقد الستينات على صعيد التنمية بالذات. وبتقديري أن سر الأردن التنموي كان ولا يزال كامنا في تفاصيل ذلك العقد، سواء من زاوية الفكر التنموي أو من زاوية الممارسة الفعلية.
كانت الستينات عقد تشغيل ماكنة التفكير الوطني في القضايا الاقتصادية ككل، ويشير الكتاب نفسه في إحدى صفحاته، إلى سنوات 1963- 1967 كسنوات إنجاز حقيقية، ولكنه يغيب ذلك في تحليله واستنتاجاته النهائية.
ربما كان عليه وعلينا، إلى اليوم، التعمق في دراسة الاقتصاد السياسي لتلك السنوات. وقد طالعت مواد أرشيفية لا تنتهي حول الطريقة التي أديرت بها الدولة حينذاك، وكيف أنشات مشاريعها الكبرى: الجامعة الأردنية مع تفاصيل أهدافها التنموية، ثم البنك المركزي كمؤسسة تشرف وتدير، ثم بنك الانماء الصناعي كرديف لمؤسسة أسبق هي مؤسسة الإقراض الزراعي، ثم تنشيط القطاع التعاوني الذي لا تزال آثاره التنموية قائمة للآن، وقد حولها التحديث إلى "أطلال" تنموية. لقد كان هدف الاكتفاء الذاتي من القمح مثلا واقعيا ومنطقيا، بدليل نتائج سنوات النصف الأول من الستينات، عندما صدرنا القمح لمصر وللسعودية. تعالوا نقترب أكثر من الاقتصاد السياسي، ففي تلك المرحلة نجد رئيس الوزراء وصفي التل يقول لرجال الأعمال الذين احتجوا على بعض الضرائب: "لا تنسوا انني تمكنت من أدخل مبلغ 40 دينار إلى جيب كل مزارع"، وهو يعني إجراءات دعم الزراعة.
وحتى على صعيد القطاع الخاص الذي كان اسمه الدارج هو "القطاع الأهلي" (لاحظوا لطف المصطلح) نجد في الأرشيف مثلا قصة شركة الانتاج التي ضمت العديد من الصناعات الطامحة التي أصبحت بعد مرحلة التحديث أشبه بالخرائب التنموية. بل ليتكم تقرأون الكلمة التي ألقاها مؤسس الشركة العربية للأدوية الراحل منير شقير حيث وضع صناعة الدواء في سياق المعركة مع العدو وهو يتساءل: كيف نحارب ونحن مكشوفون صحيا؟ لا بد من ان نصنع أدويتنا.
أستطيع في الواقع الاسترسال كثيرا في تناولالأمثلة عن أبعاد "الاقتصاد السياسي الأردني" في تلك الفترة، حتى لو لم يكن أصحابه يسمونه كذلك. كانت عين الدولة تشمل جميع مواطنيها بعدالة، ولكن مع الإصرار كما قيل حينها بوضوح على أن: تبقى الأولوية للدولة وليست لرأس المال.
يتبنى الكتاب "الخرافة" التي تقول إن القطاع العام كان قبل التسعينات مترهلا! إنها فعلا مجرد خرافة. فلم يبدأ الترهل المؤذي إلا بعد عهد "الإصلاحات" التي بدأت في تسعينات القرن الماضي، وتجلت وبرزت أكثر منذ مطلع القرن، بل تنوع الترهل وأخذا أشكالا أكثر كلفة لا سيما فيما يتعلق بالهيئات المستقلة. بالطبع أفهم أن هناك ظروفا عالمية واتجاهات اقتصادية دولية ضاغطة لا تستطيع حتى الدول الكبرى الصمود في وجهها، ولكن هذا لا يعني توجيه التهمة للمنهج السابق لصالح مناهج جديدة تفشى فيها الضرر.
هل تذكرون أن الحكومات كانت حتى مطلع الثمانينات تمنع سفر الموظف إلا بإذن من الوزير؟ لقد كانت استقالة المعلم تعلن رسميا في الصحف، وكانت الجامعات تشجع الطلاب على قبول المنحة الدراسية مع راتب شهري للطالب، مقابل التزامه بالعمل بعد التخرج، وتضع عليه العقوبات إذا لم يلتزم بالوظيفة؟
يقتضي الاقتصاد السياسي أن نسأل عن المستفيد من انحراف الاتجاه نحو الاقتراض الزائد منذ منتصف الثمانينات. وفي الأرشيف أيضا نجد أنه كان هناك من يحذر من سياسة الاقتراض في بدياتها (فهد الفانك مثلا)، وهي كما يعلم الاقتصاديون أن التوسع في الاقتراض كان بتشجيع دولي، كاستثمارات لفائض الأموال على المستوى العالمي التي يديرها صندوق النقد بهدف تحقيق الربح المضمون وبضمانة الدولة ومؤسساتها ومواردها التي سوف تخصخص لاحقا عند العجز عن السداد. وبالمناسبة، إن مصطلح "التخاصية" هو ترجمة أردنية، وقد وردت لأول مرة في مقابلة للرئيس الراحل زيد الرفاعي عام 1986، فيما كان الأشقاء المصريون قد اعتمدوا مفردة "الخصخصة" واعتمد الأشقاء في تونس مفردة "الخوصصة"، وفيما بعد ساد مصطلحنا باعتباره أكثر "وقارا" من مصطلحات الأشقاء.
يركز الكتاب في فصوله الهامة الأخيرة على الجدال في العقدين الأخيرين، بين القطاع العام ومصيره ومكوناته وبين القطاع الخاص. وبالطبع رغم تهذيب المفردات المستخدمة، إلا أن خصومة القطاع العام بما في ذلك خدمات القطاع العام التي يعرضها الكتاب تحت عناوين ضبط التكلفة، تبقى حاضرة بوضوح.
الكتاب فيه قدر ملحوظ من الجرأة في عرض مجريات النقاش الحكومي حول بعض القضايا والقوانين والإجراءات، وهي شهادات شخصية للدكتور جعفر، بما في ذلك كشفه أن احتجاجات حزيران عام 2018 التي قدمت في الشارع باعتبارها هبة شعبية لمصلحة الفقراء، هي في الواقع كانت بقيادة وبتوجيه البنوك والشركات الكبرى. وأن رئيس الوزراء وقتها هاني الملقي فضل الاستقالة على الرضوح لضغوط الكبار، بينما تبناها خلفه الدكتور عمر الرزاز، وأقر القانون الذي يخفض الضرائب على البنوك. وهذه الحادثة كانت بتقديري واحدة من "مهازل الصراع" في الأردن، بينما كان بمقدور الملاحظ المحايد أن يكتشف الغش في تلك الحركة في حينها، ولكن من يستمع وسط ضجيج ثورة الجماهير وهبل المعارضة؟
الكتاب يدافع بجرأة عن السياسات التي بالمحصلة أخذت حصة من صلاحيات الحكومات، بعد أن رأى أصحاب القرار أن الحكومات تخضع لقوى اجتماعية "تقف عائقا أمام التحديث" وتعجز عن التصدي لها.
إن على انصاره مثلما على خصومه أن يتابعوه بعناية وانتباه. من المرجح أن الكتاب قد يجسد الفلسفة الكامنة خلف الاقتصاد الذي سنراه في التطبيق في قادم الأيام، وسيكون اقتصادا سياسيا بامتياز.