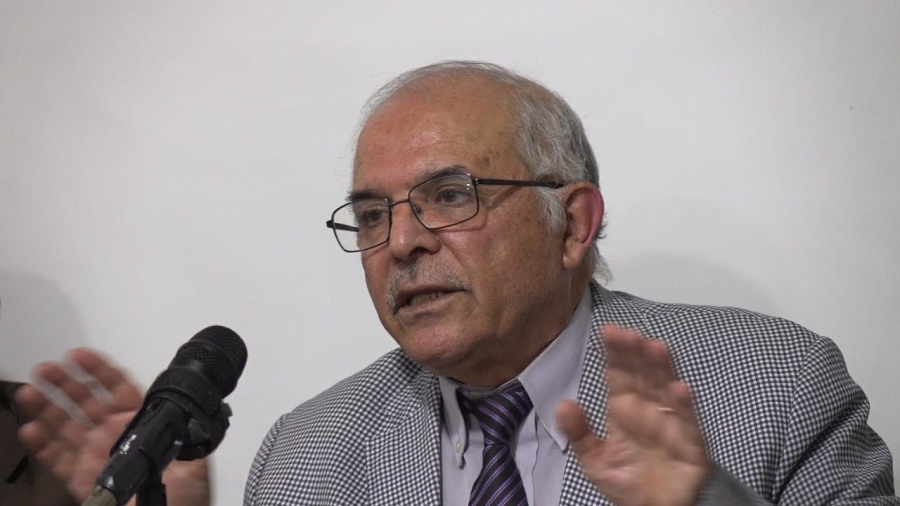من الأسلمة إلى التدين

إبراهيم غرايبة
تحتاج النخب، بما هي القيادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أن تلاحظ أنّها تاريخياً وواقعياً هي المنشئة للاتجاهات والقواعد التنظيمية والاجتماعية والأخلاقية والدينية للأفراد والمجتمعات، وأنّ الفوضى السائدة اليوم هي واحد من احتمالات ثلاثة: عجز أو نهاية أدوات التنظيم والضبط المستخدمة، أو إرادة نخبوية بالفوضى والتفكيك تجري بوعي مسبق كوسيلة جديدة أو استجابة في مواجهة التحولات الاجتماعية الكبرى التي تجري اليوم.
ليست المطالبة القوية بالحريات والكرامة والعدالة سوى جزء ضئيل من هذه التحولات، وما تفعله النخب ليس سوى وضع المجتمعات والطبقات أمام خيارين: الإذعان مع الأمان، أو الحرية مع الفوضى، أو نهاية النخب والأفكار السائدة، وهذا ما أرجحه بسبب المنطق التاريخي لمسار الأمم، لتنشأ منظومة اجتماعية وفكرية جديدة وعقد اجتماعي جديد، واتجاهات ثقافية جديدة، وقيم وأفكار جديدة.
عندما تكون ماكينة تعمل لصالحنا، فإننا ننشغل بالدفاع عنها وحمايتها؛ بل وتقديسها، ولا ننشغل أبداً بالسؤال كيف تعمل، لكن عندما تتوقف أو تعمل بطريقة لا تفيدنا أو تضر بنا تتحول إلى سؤال، ونبدأ بالتفكير لاستعادتها أو حرمان الآخرين منها أو تدميرها إذا اقتضى الأمر، لكننا نادراً ما ننشغل بفهم الأسباب والقواعد التي كانت تعمل على أساسها. ماكينة الدين، على سبيل المثال، ظلّت تعمل قروناً متطاولة لصالح السلطة السياسية، لم تكن سوى أداة السلطة لاكتساب الشرعية والتأييد وضبط الأفراد والمجتمعات وتنشئتهم وفق مصالح وتوقعات النخبة السياسية. ولم يعد الدين سؤالاً يشغل النخب والسلطات إلا عندما صار محركاً للمعارضة والاحتجاج والخروج من المجتمعات كما الخروج عليها! وكانت السلطات في صراعها مع الجماعات الدينية المعارضة تقاتل لأجل استعادة الدين وليس لأجل الاعتدال أو التسامح أو الصواب الديني أو مواجهة الانحراف عن الدين! لكن السلطات تجد نفسها اليوم في مواجهة شبكات اجتماعية واسعة تلجأ إلى الدين في مواجهتها مع السلطة وهي في الوقت نفسه لا علاقة لها بجماعة منظمة أو معروفة!
وكما في الدين ففي السياسة والاجتماع أيضاً، تتحرك في مواجهة السلطة والنخب شبكة واسعة وعميقة من النقاط المجهولة بالنسبة للسلطات، والتي لن يفيد في تنظيمها أو استيعابها سوى عقد اجتماعي جديد يأخذ بالاعتبار إمكانيات الشبكية وتحدياتها.
يبدو الدين مرشحاً ليأخذ موقعاً جديداً ومختلفاً في عالم العرب والمسلمين، ما يدعو إلى هذا التقدير هو حالتان جديدتان على الأقل تتشكلان؛ أولاهما مراجعة الحالة الدينية الجارية اليوم، والثانية صعود الفردية في ظلّ الشبكية التي تعيد صياغة علاقات القوة والتأثير والتنظيم في الدول والمجتمعات، وفي ذلك فإنّ في مقدور الفرد اليوم أن يتدين بلا حاجة إلى مؤسسة دينية أو سلطة سياسية. وسواء تزايد أو تراجع تأثير الدين ووجوده في حياة الناس وتصوراتهم والحقائق الأساسية المحيطة بالكون والحياة فإنّه يتخذ أوضاعاً جديدة ومعاني جديدة أيضاً؛ فالنص الديني يقرأ في سياق العلاقة به، ويفهم ويتشكل كما يقرأ، وفي استيعاب الإنسان لشبكة الدلالات التي صنعها بنفسه ويجد نفسه جزءاً منها، فإنّه ينشئ نظامه الثقافي ورؤيته لحياته وعالمه الخاص.
صحيح أنّ هناك فرقاً بين الدين والثقافة؛ فالمتدين يرى الدين رسالة من الإله لترشده في حياته وبعد مماته، لكن لا مناص من فهم هذه الرسالة وملاحظتها في ظل الثقافة والتجارب الإنسانية المتشكلة، وليس ذلك لإثبات صواب الدين أو خطئه، حتى وإن كان الدين في حالته الأصلية النقية أكبر من قدرات الإنسان وكانت الثقافة من صنع الإنسان، لكن لا مفر من فهم الدين ودراسته بالأدوات الإنسانية، العلم واللغة والتجربة والحضارة، وأن يؤمن الإنسان، فرداً أو جماعات، بالدين على النحو الذي تعبر عنه النصوص الدينية؛ لا يغير أيضاً من حقيقة أنّ الثقافة والدين هما من مظاهر حياة الإنسان (غير الدينية)، وعلى الرغم من أنّ هذه المقولة صارت بديهية في عالم الغرب، وتكونت في ذلك معرفة واسعة ومكتبة هائلة من الكتب والدراسات والأفلام والمسرحيات والروايات والقصص والفنون،.. فما تزال في عالم العرب فكرة خيالية متطرفة!
كان من أسوأ ما أصاب عمليات التحديث والاستيعاب المعاصر للإسلام التي بدأت في ظل الدولة العربية الحديثة، هو إعادة فهم المعارف والمنجزات الغربية بمنظور إسلامي بدلاً من العكس؛ أي دراسة الدين وإعادة فهمه بمدخلات العلوم الحديثة التي تطورت في عالم الغرب، فصار لدينا أنظمة إسلامية في السياسة والاقتصاد والبنوك والتعليم والإعلام وأسلوب الحياة والعمارة، هي ليست إسلاماً وليست حضارة، بدلاً من أن يكون لدينا عمليات فهم واستيعاب للدين في فضائه العام بما هو حالة أو ظاهرة ثقافية أو اجتماعية فيكون لدينا سوسيولوجيا الإسلام وأنثروبولوجيا الإسلام وبيولوجيا السلوك الإسلامي،.. أو في عبارة أخرى كان يجب أن يكون لدينا أنسنة الدين بدلاً من تديين الإنساني، ففي الأنسنة يكون في مقدورنا أن ننشئ حياتنا كما يجب وكما نحب أن تكون ويكون الدين في السياق المعرفي والاجتماعي الذي يخدم هذا الاتجاه، أو يكون التدين هو ما نتوقعه من الدين بما تمنحنا هذه التوقعات مدركاتنا الحضارية والاجتماعية، لكن في التدين فقد مضينا بحياتنا وشأننا المشهود لنخضعه للغيب الذي لا يعرفه أو يدركه أحد، وفي ظل غياب هذا الإدراك صارت تقود حياتنا مؤسسات وجماعات تنشئ معرفتها وقراءتها وفهمها للدين، وصار الدين هو ما تتوقعه ّ السلطات الدينية والسياسية، وتصف توقعاتها منا والتي هي مطالب وطموحات وأهواء سلطوية بأنها الدين أو كما في القرآن "ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله".. لكنّنا نملك اليوم فرصة عظيمة في صعود الفردية وتدفق المعرفة وتداولها وإنتاجها على نطاق واسع يتاح لكل إنسان أن يشارك فيه، أن ننشئ حاضراً جديداً نحدده من معطيات الحاضر نفسه، غير ملزمين بالمؤسسات والمنجزات التي لم يعد لها مبرر، ولن تكون موجودة في المستقبل القريب.